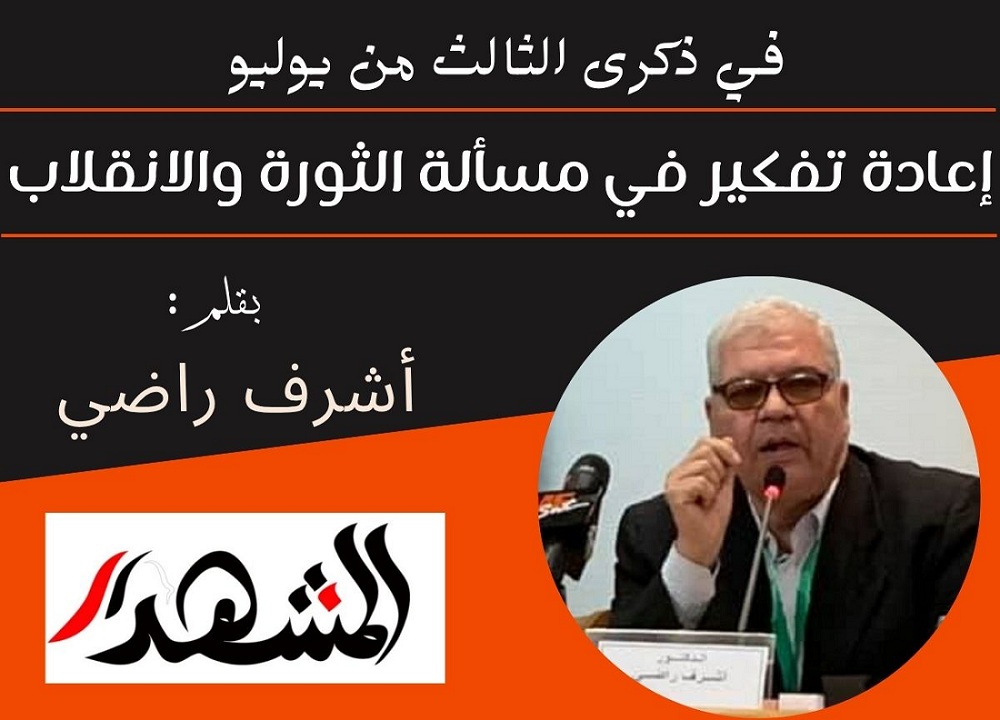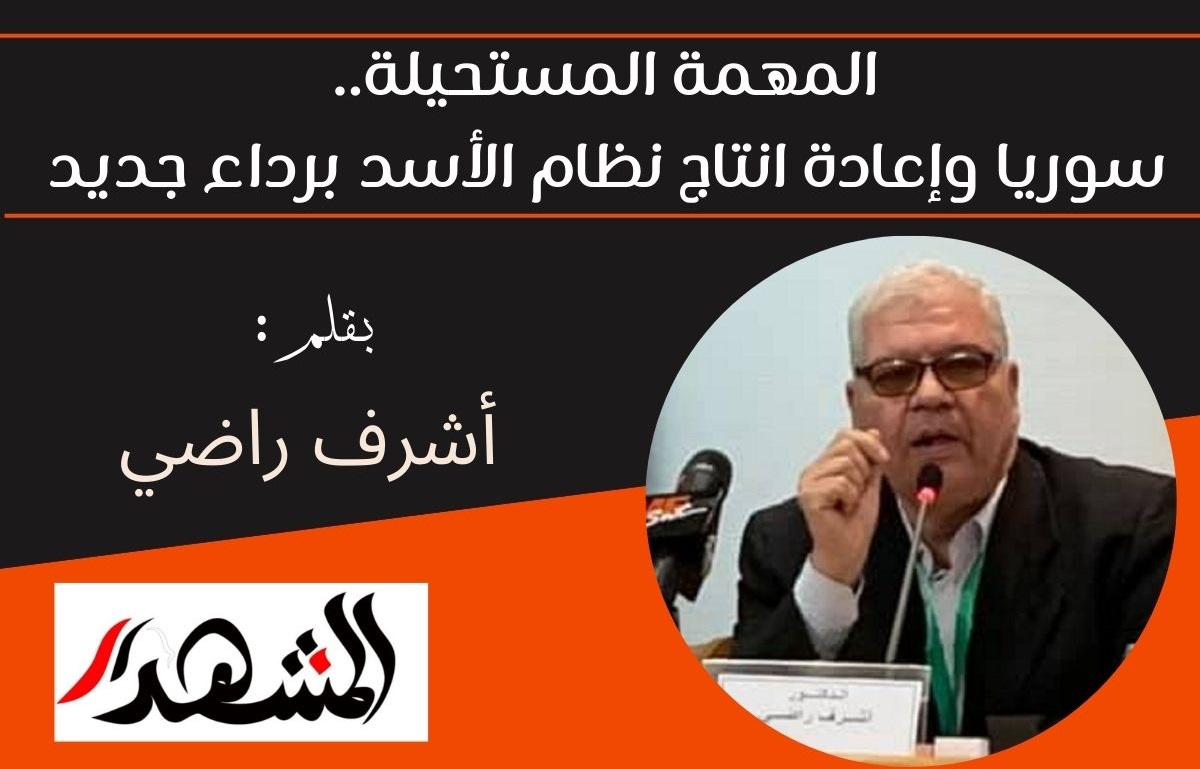ينقسم الرأي بخصوص "ثورة" 30 يونيو 2013، مثلما ينقسم بخصوص "ثورة" 25 يناير 2011. هذا الانقسام في الرأي لا يقتصر فقط على مواقف المصريين من الحدثين الكبيرين، وهي مواقف تتلون وفق الموقف السياسي أو الفكري للمنتمين لهذا التيار أو ذاك، وإنما يمتد أيضا للمراقبين من الخارج، من صحفيين وباحثين وخبراء. لكن الخلاف في الرأي في الحالة الثانية لا يرتبط فقط بميول الصحفي أو الخبير أو الباحث، فمن المفترض أن يعتمد هؤلاء بحكم الأخلاقيات الحاكمة لوظيفتهم على مجموعة من المعايير التي تقلل إلى أدنى حد ممكن التحيزات السياسية أو الثقافية.
لا ينطبق وصف "الثورة"، بالضرورة، على أي حراك جماهيري واسع النطاق. فقد يكون هذا الحراك "انتفاضة شعبية"، شاركت فيها حشود غاضبة، وقد تكون عملاً مدبراً، تضافرت لتنفيذه قوى سياسية داخلية وخارجية، معلنة وغير معلنة لتحقيق غاية محددة، وهو أمر ينطوي على مخاطرة كبيرة نظراً لخطورة التحكم في الحشود الضخمة. إن مفهوم الثورة من أكثر المفاهيم مراوغة في الدراسات السياسية والاجتماعية، على الرغم من التراكم البحثي والمعرفي، والذي أثرى نظريات الثورة. وتطرقت لهذا الأمر في مقدمة بحث، لا يزال قيد التطوير، عن "ثورة 1919 والأدبيات النظرية عن الثورة"، وعرضت بعض النتائج التي خلصت إليها في إحدى الجلسات التي نظمت في إطار الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مئوية ثورة 1919، في نوفمبر 2019.
التغيير: بين الإصلاح والانقلاب والثورة
إن الوقوف على حقيقة الأحداث، أحد الإشكاليات الكبرى في البحوث والدراسات التي تتناول ظواهر اجتماعية أو أحداث سياسية، خصوصاً إذا كانت في ضخامة حدث مثل الثورة، التي تتضافر لحدوثها عوامل كثيرة، لا يمكن لأي طرف أن يدعي قدرته على التحكم فيها أو السيطرة عليها، كل ما يمكن للأطراف المتصارعة أن تفعله هو محاولة التأثير على مسارها ونتائجها المرجوة، وغالباً ما تكون النتائج مغايرة لما كان مأمولاً. وقد رصد هذه المسألة إدوارد كار أستاذ تاريخ الدبلوماسية البريطاني في دراسته الرائعة والمدعومة بالوثائق عن "ثورة البلاشفة" التي صدرت ترجمه عربية رائعة لها في ثلاثة أجزاء من الهيئة المصرية العامة للكتاب، في عام 1973. أوضح كار في دراسته كيف كان قرار ألمانيا بإرسال فلاديمير لينين من برلين إلى موسكو حاسماً، إلى جانب عوامل أخرى مساعدة، في سيطرة البلاشفة الذين كانوا أقلية في الحزب الشيوعي الروسي على السلطة وتوجيه مسار الثورة، وكيف كان للانقسامات فيما بين البلاشفة بعد اغتيال تأثير في انقسام الحركة الشيوعية العالمية بين الأممية الثالثة والأممية الرابع؟ كذلك كان إرسال آية الله الخميني في طائرة من باريس حاسماُ في تغيير مسار ثورة "البازار" في إيران والتي كانت ثورة اجتماعية بامتياز لتصبح ثورة إسلامية تمكن رجال الدين الشيعة من الهيمنة على إيران ما بعد الشاه وتوجيه سياساتها وفقاً لرؤيتهم الأيديولوجية. ولم تكن الانتفاضات التي شهدتها دول عربية في عام 2011، استثناء، فالمسارات المختلفة التي سارت فيها تلك الانتفاضات كانت محصلة لصراعات عنيفة ومعقدة بين قوى داخلية وإقليمية وعالمية على النحو الذي بينته الحالة الليبية والسورية واليمنية وفي البحرين. واختلف الأمر في مصر وتونس لكثير من الاعتبارات تتصل بقدرة الأطراف الوطنية على الحسم مبكراً والسيطرة على الوضع، وأبقت على الصراع السياسي في حدوده الوطنية بقدر الإمكان.
من الشائع، أن الانتفاضات التي تنجح في إحداث تغيير جذري في علاقات القوى داخل المجتمع وتتمكن من التصدي للتحالفات الإقليمية والدولية، هي التي توصف بالثورة، الأمر الذي يقصر تعريف الثورة على عدد قليل من حالات التغيير القادمة من القوى الاجتماعية، والتي أسفرت عن نتائج غيرت في شكل العلاقات التي كانت قائمة من قبل، ولذلك يقتصر الثورة على عدد قليل من الحالات بدءًا من الثورة في الفرنسية التي استمرت لأكثر من 40 عاماً حتى تمكنت من حسم الصراعات داخل فرنسا، على النحو الذي يرصده كارل ماركس في كتاباته عن فرنسا، وخصوصاً كتاب "الحرب الأهلية في فرنسا" و"الثامن عشر من بروميير"، وغيره من دراسات وكتب عن الثورة الفرنسية. أيضاً تستحق الثورة الأمريكية هذا الوصف لأنها أسست لوضع جديد بإعلان الاستقلال الأمريكي، والثورة الروسية 1917، والثورة المصرية 1919، والثورة الصينية 1949، والثورة الإيرانية 1979. لكن لم تكن هذه التغييرات متوافقة بالضرورة، عن تطلعات الزعماء الذين مهدوا للثورة أو تصدوا لقيادتها في المراحل الأولى.
وإذا كان إحداث التغيير سمة أساسية للثورات، إلا ان هذا التغيير قد يأتي أيضا نتيجة لإصلاح ما تجريه السلطة الحاكمة وتدفع من أجل إحداثه قوى اجتماعية، وقد يأتي التغيير، أيضاً، نتيجة لانقلابات داخل دوائر السلطة. ربما كانت جذرية التغيير وسرعة وتيرته مؤشراً أساسياً للتمييز بين التغيير الناتج عن ثورة أو انقلاب عنيف على السلطة، أو ذلك الناتج عن عمليات إصلاحية. وإذا مضى التغيير الجذري في اتجاه مضاد لما كانت تتطلع إليه القوى الثورية، فإنه يطلق على هذه العملية "الثورة المضادة"، والتي لا تبقي عادة على توازنات القوى وترتيبات المصالح على الوضع الذي كانت عليه قبل الانتفاضات الاجتماعية الواسعة، وإنما تعيد تشكيلها بصورة جذرية وعنيفة لصالح القوى التي تمكنت من السيطرة على السلطة. المهم عند دراسة الثورات والانقلابات وعمليات الإصلاح النظر إلى مضمون التغيير ووجهته، وما إذا كان يمضي في اتجاه الانتقال إلى وضع أفضل من الوضع القديم من وجهة نظر الغالبية العظمى من المواطنين أم إلى وضع أسوأ. بالنسبة لعالمة السياسية الألمانية الأصل، حنة أرندت، فإن الثورة فقط الثورة من أجل المزيد من الحرية للمجتمعات والأفراد، بينما يميل منظرون آخرون إلى التركيز على إعادة تشكيل المجتمع والعلاقات بين القوى الاجتماعية للحكم على وجود ثورة من عدمه. وفي هذا الصدد يشيرون إلى حالات في التاريخ لانقلابات أحدث تغييرات اجتماعية وسياسية جذرية في المجتمع، مثلما حدث في مصر في أعقاب حركة الضباط في 23 يوليو 1952. لكن التركيز على اللحظة التي قادت التغيير والموقع الذي يشغله القائم بالتغيير للتمييز بين الثورات وعمليات الهندسية الاجتماعية والسياسية العنيفة التي يجريها القائمون على السلطة.
الشرط الذاتي والظرف الموضوعي
تشير العديد من الدراسات عن الثورات، أن الثورة تنجح نتيجة لالتقاء الشرط الذاتي مع الظروف الموضوعية التي تدفع القوى الاجتماعية للثورة على الأوضاع القائمة. والمقصود بالشرط الذاتي هو وجود قوى سياسية وجماعات ثقافية وفكرية تدفع في اتجاه الثورة، من خلال طرح أفكار ومفاهيم وتصورات جديدة، أو من خلال العمل المنظمة لحشد الجماهير وتحريضهم على الثورة. ولا يمكن لهذه القوى أن تحقق أي نجاح إذا لم تكن هناك ظروف موضوعية تدفع الناس للثورة. ويقصد بالظروف الموضوعية حدة التناقضات الاجتماعية واحتدام الصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية على نحو يصعب معه استمرار الأمور على ما هي عليه. قد تتوافر الظروف الموضوعية للثورة لكن دون توافر الشرط الذاتي، الحزب الثوري أو الطليعة الثورية المنظمة القادرة على حشد الجماهير والاستيلاء على السلطة من خلال التنظيم، في هذه الحالة لا تحدث أيضاً الثورة، وإنما قد تحدث انفجارات اجتماعية أو انتفاضات أو هبات جماهيرية عفوية واسعة النطاق دون وجود تنظيم أو طليعة منظمة، ونتيجة أيضاً لعجز القوى الإصلاحية على التدخل. الثورات تنجح فقط عندما يكون هناك توافق بين الشرط الذاتي والظروف الموضوعية. وقد تمثل الحالة المصرية حالة نموذجية لاختبار هذه الفرضية.
تصف الدراسات السياسية والاجتماعية لمصر منذ ثلاثينات القرن الماضي، بأن مصر في حالة ثورية أو في وضع ثوري، نتيجة لاحتدام التناقضات الاجتماعية والصراعات الاجتماعية والسياسية نتيجة لصعود الطبقات الوسطى في المدن بسبب عمليات التحضر الاجتماعي، وتعرض المجتمع لمؤثرات فكرية شتى. ربما تجسد رواية "القاهرة الجديدة" لنجيب محفوظ هذه الحالة التي يمر بها المجتمع المصري، وبلغت حدة الصراع الاجتماعي والتناقضات الاجتماعية ذروتها في الفترة بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945، على النحو الذي يرصده المستشار الراحل طارق البشري في كتابه "الحركة الوطنية المصرية: 1945- 1952"، ودراسات الدكتور أنور عبد الملك ودراسات أخرى تناولت هذه الفترة. وعلى الرغم من الإصلاحات الجذرية التي أجراها نظام الرئيس جمال عبد الناصر بدء من الستينات، إلا أن هذه الإصلاحات لم تحدث التغيير الجذري المنشود في موازين القوى الاجتماعية بسبب طبيعة النظام السياسي المحافظة، وبالتالي كان من السهل الانقلاب على هذه الإصلاحات وتغيير وجهتها، وكانت السلطة الحاكمة هي اللاعب الحاسم في الحالتين، نتيجة للإضعاف المستمر للوكالات الاجتماعية، وحرمان المجتمع من قدراته التنظيمية ومن الآليات التي تساعده على بناء منظمات مستقلة عن السلطة والدولة، وعدم حدوث التمايز من خلال وجود قاعدة اجتماعية للأحزاب والمنظمات السياسية، إلا في عدد محدود للغاية من الحالات وبشكل استثنائي، نتيجة لميل العلاقات بين الدولة والمجتمع بشدة لصالح الدولة ومؤسساتها وأجهزتها على حساب المجتمع، وهذه مسألة يرصدها بدقة عالم الجغرافيا المصري الراحل، جمال حمدان في عمله الموسوعي، "شخصية مصر"، وخصوصاً في الجزء الرابع الذي يتحدث فيه عن قدرة الدولة المصرية على إعادة تشكيل المجتمع نتيجة لتحكمها في توزيع الموارد الاجتماعية والثروة. قد تقدم دراسات عالم السياسة المصري نزيه الأيوبي عن الدولة المركزية، أو كتابات المفكر المصري الماركسي الراحل أحمد صادق سعد عن تاريخ مصر الاقتصادي الاجتماعي وكذلك كتاب في "أصول المسألة المصرية، بعض التفسيرات لهذا الاختلال، لكنها لا تقدم إجابات بخصوص كيفية إصلاح هذا الاختلال في العلاقات، والتي يتصل معظمها بكيفية بناء المجال العام السياسي.
لا يمكن فهم ما حدث في مصر في أعقاب 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، إلا في ضوء غياب الحياة السياسية، ولا يمكن فهم هذه الحالة إلا من خلال القيود الشديدة التي تفرضها السلطة على حرية التنظيم التي تجسر الفجوة بين السياسة والمصالح الاجتماعية والاقتصادية. وتكمن المشكلة في الرهان على السلطة لبناء المجال السياسي، وهو أمر من المستبعد بشدة حدوثه، لا سيما في ظل الاتجاه العام في هذه المرحلة التاريخية على المستوى العالمي لتأميم السياسة ومصادرتها تحت مسميات مختلفة، والتركيز على الجوانب التقنية للسلطة وإدارة شؤون الحكم من خلال تصورات مجموعات التكنوقراط أو خبراء السلطة على النحو الذي يرصده عالم الاجتماع والمنظر الألماني يورجين هابرماس بشكل عام، ويرصده عالم التاريخ الأمريكي تيموثي ميتشيل في دراسة له عن مصر. لقد جرى الانقلاب على تطلعات القوى التي خرجت في 25 يناير وتمكنت من الاعتصام في ميدان التحرير لمدة 18 يوماً بقوة الجماهير الغفيرة التي خرجت يوم 28 يناير 2011، عبر الاستفتاء على الدستور الذي جرى يوم 19 مارس منذ ذلك العام وما اتبعه من تطورات. لقد كان الإصرار على الإبقاء على دستور 1971 مع إدخال بعض التعديلات، التي تبين هشاشتها فيما بعد، مؤشرا على عدم رغبة القوى التي رسمت هذا المسار للأحداث على عدم السماح بحدوث التغييرات التي كشفت عنها الانتفاضة على النحو الذي يمس موازين القوى الاجتماعية ووضع السلطة القائمة، من خلال التحالف مع تياري الإسلام السياسي الرئيسيين.
وكانت الانقلابات على التعديلات الدستورية في 19 مارس نتيجة متوقعة بسبب الكيفية التي أديرت بها المرحلة الانتقالية التي أعقبت تخلي الرئيس مبارك عن مهامه والرهان على جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لاحتواء مطالب التغيير الجذري والانتقال إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي حديث. مرة أخرى نزلت الجماهير إلى الشوارع احتجاجاً على الانقلاب الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012، واستمر الحشد الجماهيري ضد سياسات الإخوان المسلمين وبرامج أخونة مؤسسات الدولة منذ ذلك التاريخ وبلغت ذروتها في 30 يونيو 2013، نتيجة العجز عن التوصل إلى تفاهم فيما بين القوى السياسية المختلفة التي كانت على حالة من الضعف التنظيمي لطرح صيغة بديلة لحكم الإخواني تتجاوز مسألة الإطاحة بحكهم على النحو الذي جسدته تجربة "حركة تمرد"، التي لاقت تجاوبا وتشجيعا من داخل دوائر في مؤسسات الدولة. وكان تدخل قادة الجيش ضرورياً في 2013، مثلما كان تدخلهم ضرورياً وحاسما في 2011، وأيضاً في 1952، باعتباره القوة الأقوى والأكثر تنظيما في المجتمع، وهو ما حدث في الثالث من يوليو، من خلال سلسلة من القرارات، أعلنها الفريق عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع، آنذاك، في خطاب ألقاه في نهاية اجتماع حضرته شخصيات سياسية من المعارضة وقيادات دينية وشخصيات عامة.
النفور من السياسة: الأزمة والحل
لسنا هنا بصدد توجيه الاتهام لأي طرف بالمسؤولية عن فشل النخبة السياسية في مصر في التوصل إلى توافق عام ينهي الأزمة الناجمة عن سياسات جماعة الإخوان، فهذا الفشل ناجم عن أسباب تاريخية وبنائية، في مقدمتها غياب المجال العام السياسي وضعف التنظيمات السياسية نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه، وفي تقديري أن المسؤولية الأكبر تقع على القائمين على السلطة، لأنهم يمتلكون الموارد والقدرات تسمح ببناء المجال السياسي العام، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية المعزول، محمد مرسي، يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية بسبب فشله في تقديم تصور للخروج من الأزمة والتفاهم مع القوى السياسية المعارضة له واحتواء الجماهير الغاضبة من سياساته، على النحو الذي تأكد في الخطاب الذي ألقاه مساء 2 يوليو، والذي رفض فيه الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضه ورفض قيادات جماعة الإخوان المسلمين حضور الاجتماعات التي دعت إليها القوات المسلحة لحل الأزمة وكان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم 3 يوليو وانتهى بإعلان القرارات أنهت، عملياً، حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان لمصر الذي استمر عاماً. جرى في مقدمة الخطاب تأكيد استدعاء القوات المسلحة المصرية للقيام بدورها الوطني، والتزامها بأن تظل بعيدة عن العمل السياسي. هذا التمييز بين الدور الوطني للقوات المسلحة وبين العمل السياسي مهم للغاية، لكن لا ينبغي أن يكون سبباً للوضع أو الحالة التي عليها العمل السياسي في مصر منذ عام 1952، وضرورة الاقتناع بأن السياسة آلية مهمة لترشيد العمل الوطني وتوجيهه، وأن دور القائمين على السلطة في إصلاح هذا الوضع ضروري وحاسم، وهو ما يدركه الرئيس عبد الفتاح السيسي جيداً وعبر عنه في دعوته لإجراء حوار وطني شامل في 28 أبريل 2022، لكن ترجمة هذا الإدراك إلى برنامج عمل يزيل معوقات العمل السياسي تظل أمراً بعيد المنال.
ورسم هذا الخطاب خارطة للمستقبل لبناء مجتمع مصري قوي ومتماسك بإنهاء حالة الصراع والانقسام، وعكست هذه الخريطة نفورا ما من السياسيين وتفضيلاً لحكومة الكفاءات الوطنية، وترسيخا لفكرة حكم التكنوقراط، ولا خلاف على أهمية التكنوقراط أو الخبراء، لكن لا ينبغي أن يكون هؤلاء بديلاً للسياسية والسياسيين. ربما كان البند الوحيد المؤجل في هذا الإعلان هو البند الذي يدعو إلى "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية"، وحدد هذا البند مواصفات لأعضاء هذه اللجنة بأن يكونوا "شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات"، وهي صياغة عامة لا توفر آليات لتحقيق المصالحة.
لقد كتبت قبل انتخابات الرئاسة في عام 2012، سلسلة مقالات تحت عنوان "في الطريق إلى انتخابات الرئاسة" على موقع مصر المدنية، أشرت في إحداها إلى أن رئيس مصر القادم عليه أن يدرك أن يقود مجتمعا منقسماً وأن يعطي الأولوية لوضع خطة أو برنامج عمل للتعامل مع هذه الحقيقة، ونوهت في أكثر من تعليق إلى أن ما تشهده مصر في ذلك الوقت لم يكن عملية للانتقال الديمقراطي، وإنما صراع على السلطة، يجب تنظيمه على نحو يفتح الطريق أمام حدوث تحول ديمقراطي، لكن كانت إدارة المرحلة الانتقالية الأولى (2011-2012) منشغلة بصراعات وترتيبات للسلطة ضاعت معها هذه الفرصة عبر سلسلة من المناورات السياسية والحزبية الصغير بغرض الإبقاء على الترتيبات الحاكمة لعلاقات السلطة كما هي. وفي المرحلة الانتقالية الثانية (2013-2014)، تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية، بغرض التعامل مع ضعف المجتمع السياسي المصري، لكن تم إلغاء هذا المنصب لاحقاً، دون حل لهذه المشكلة، التي تجعل المستقبل رهينة للصراع بين القلعة والمعبد، أي بين قوة المؤسسة العسكرية، والجماعات التي تتستر بالدين لتأسيس شرعيتها السياسية.
الآن، وبعد مرور 12 عاماً على الثالث من يوليو، ألم يحن الوقت للتفكير في مسار آخر للشروع في إصلاحات سياسية وتشريعية تسمح ببناء المجال السياسي، لبنتها الأساسية بناء أحزاب سياسية قوية، ألم يحن الوقت لإدراك أنه لم يكن هناك تأثير أو وزن للمتسترين بالدين من أجل تحقيق غايات سياسية، حينما كان في مصر مجتمع سياسي قوي، يستند إلى تجربة حزبية تعددية، حتى بالرغم من أن تداول السلطة نتيجة للانتخابات كان مقيداً. إذا لم نكن ندرك ذلك، علينا الرجوع إلى نتائج انتخابات 1951 ودراستها جيداً. ومن شأن الإقدام على إحداث هذه الإصلاحات السياسية الضرورية وتحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والعمل على رفع نسبة الإقبال على التصويت بمنح الحرية للأحزاب المتنافسة للعمل وسط الجماهير بحرية ومسؤولية، ومن شأنه أن ينهي الانقسام حول 30 يونيو وهل هو ثورة أم انقلاب؟
--------------------------
بقلم: أشرف راضي